بين الاستباحة والاستغلال | الفلسطينيّات في المصانع الإسرائيليّة

تقول الأسطورة الإغريقيّة إنّ ميدوسا كانت خادمة في «معبد الآلهة» بأثينا، أغواها إله البحار ’بوسيدون‘، ومارست الجنس معه داخل المعبد، فعاقبتها إلهة الحكمة مستبدلة خصلات شعرها بالثعابين، وحوّلتها إلى فتاة غاية في القبح، كلّ من ينظر إليها يصبح تمثالًا من حجارة.
تبدو هذه الحكاية الميثولوجيّة شبيهة بحال النساء الفلسطينيّات اللواتي يعملن في المستوطنات والمصانع الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة، ويتعرّضن للتحرّش الجنسيّ من قِبَل المستوطنين المشغّلين لهنّ. على الرغم من وجود تاريخ طويل للعنف الجنسيّ ضدّهن في سياق الاستعمار الاستيطانيّ، إلّا أنّ جدليّة ظاهرة التحرّش في مكان العمل الإسرائيليّ، تكمن في وقوع المرأة الفلسطينيّة خارج القانون بالنسبة إلى المستعمِر من جهة، وبالتالي فإنّ حقوقها مهدورة، وجسدها وروحها مستباحان، وكذلك وقوع المستوطن نفسه خارج القانون بالنسبة إلى المؤسّسات الرسميّة والحقوقيّة الفلسطينيّة من جهة أخرى؛ ما يجعل مطالبة المرأة المعنَّفة بحقّها شيئًا لا جدوى منه حال لجوئها إلى هذه المؤسّسات.
الحاجة إلى المال، وانعدام فرص العمل في الضفّة الغربيّة، عاملان أساسيّان لتمسّك النساء الفلسطينيّات بعملهنّ داخل المستوطنات...
لا تسعى هذه المقالة إلى استعراض العنف الجنسيّ الموجّه الّذي يمارسه الإسرائيليّ على المرأة الفلسطينيّة، بل تركّز على تفكيك جذور هذا العنف وفهمه، وآليّة نشوئه، ودائريّته؛ إذ تفترض وجود بنية عميقة على المستويين الفلسطينيّ والإسرائيليّ - أي السمسار الفلسطينيّ والسمسار الإسرائيليّ - تخلق نمطًا ثابتًا من الاختيار للنساء العاملات في المصانع، وتساهم في التطبيع مع العنف الاستعماريّ.
الميدوسا في عمارتنا
أذكر أنّ امرأة مطلّقة سكنت ذات العمارة الّتي سكنتُها قبل سنوات، كانت تعمل في مصنع لمستحضرات التجميل في ’مستوطنة بركان‘ الصناعيّة. حذّرني أقاربي من التعامل معها أو الخروج برفقتها، لأنّها ليست ’امرأة سويّة‘ على حدّ قولهم. والسبب يعود لعملها في المصنع الإسرائيليّ، وتخلّيها عن الحجاب، وقبولها الذهاب إلى العمل في سيّارة مليئة بالرجال، فضلًا على رضا والدها وعدم اعتراضه على سلوكيّاتها. هذه المجموعة من التصرّفات إشكاليّة في نظر المجتمع، ومصير صاحبتها النبذ والإقصاء، والتعامل ضمن أضيق الحدود.
في الواقع، كان لهذه المرأة حكاية مختلفة: فقد أنجبت ابنها ميّتًا، وتعرّضت للعنف من قِبَل طليقها، وأُجبِرَت على العمل لإعالة ابنتيها لأنّ والدها رفض إعالتهنّ. تعرّفت على رجل يعمل سمسارًا، واقترح عليها العمل في مصنع إسرائيليّ، وساعدها على توطيد علاقتها ببعض المسؤولين الإسرائيليّين؛ إذ يعاملها المستوطِن الّذي يشغِّلها بلطف شديد، ويمنحها الإجازات دون اقتطاع من راتبها. قالت لي مرّة إنّها تستقبل لطافته مضطرّة، كي لا تخسر مصدر رزقها الوحيد.
الحاجة إلى المال، وانعدام فرص العمل في الضفّة الغربيّة، عاملان أساسيّان لتمسّك النساء الفلسطينيّات بعملهنّ داخل المستوطنات. وهنا يتّضح الشبه بينهنّ وبين الميدوسا، إذ هنّ أيضًا ضحايا الأبويّة والاستعمار، ويتعرّضن لعنف دائريّ أو ما أسمته نادرة شلهوب – كيفوركيان[1] بـ ’الاستباحات الحلزونيّة‘؛ فالعنف الّذي يتعرّضن له من قِبَل المجتمع الفلسطينيّ لا يتعلّق بالنظرة السلبيّة لعملهنّ فحسب، وإنّما بالطريقة الّتي يتعامل بها السمسار الفلسطينيّ معهنّ، وآليّة اختياره لهنّ. مثلًا، يفضّل أن تكون العاملة حاصلة على شهادة الثانويّة العامّة حدًّا أعلى، وفي حاجة شديدة إلى المال؛ حتّى تبقى في المصنع لأطول فترة ممكنة.
التكنولوجيا السياسيّة للجسد
يؤثّر المستوى التعليميّ في مدى رضا المرأة عن وضعها عاملة في المستوطنة من جهة، وفي طريقة تعامل الإسرائيليّ معها من جهة أخرى؛ فالمرأة المتعلّمة كما يراها السمسار، لن تقبل التعنيف، بخلاف المرأة غير المتعلّمة الّتي ستتقبّله وتحاول التحايل عليه أو تجاهله. أمّا على الصعيد الإسرائيليّ؛ فالمتعلّمة تشكّل خطرًا، حتّى على مستوى اللغة العبريّة وإن كانت لا تجيدها، ويبقى التعامل معها أكثر حذرًا.
من اللافت أيضًا أنّ السمسار الفلسطينيّ يختار النساء العاملات من مناطق جغرافيّة بعيدة عن مدينته، حتّى يجرّد نفسه من أيّة مسؤوليّة حال تعرّضها للأذى. في مقابلة سابقة أجريتها مع فتاة عملت في مصنع تمر إسرائيليّ في منطقة أريحا، أخبرتني أنّ المسافة من بيتها إلى العمل نحو 45 دقيقة. وتقع مسؤوليّة تغطية ثمن المواصلات على السمسار، ورغم قدرته على اختيار عاملات من منطقته، لكنّه لا يريد توريط نفسه في عمل لا عقود فيه، ومخاطره كبيرة.
يؤثّر المستوى التعليميّ في مدى رضا المرأة عن وضعها عاملة في المستوطنة من جهة، وفي طريقة تعامل الإسرائيليّ معها من جهة أخرى
إلى جانب التعليم والجغرافيا، تحضر الطبقة الاجتماعيّة الّتي غالبًا ما تكون تحصيل حاصل، إذ من النادر أن تعمل امرأة في المستوطنة ما لم تكن في حاجة ماسّة إلى المال، وهو السبب ذاته الّذي يدفع السمسار الفلسطينيّ إلى تشغيلهنّ؛ فالطبقة الدنيا، خاصّة نساء القرى، أكثر انخراطًا في هذه المهن، لكن، كيف تَشكَّل هذا الثالوث؟
في السياق اللامرئيّ للسياسة الحيويّة، وترحيل إسرائيل للقتل مقابل استثمارها للحياة، ولكن دون الانخراط الفعليّ أو المبالاة بحياة الشعب المستعمَر، نلاحظ توظيفها السمسار الفلسطينيّ بوصفها حارسًا/ ضابطًا، يقرّر مَن من النساء يحقّ لها العمل في المستوطنة، كيف، ومع مَن. إذ تجلّى هذا الاهتمام في ظلّ تطوّر نظام اقتصاديّ ناشئ مع أيديولوجيّة ليبراليّة، ليست استجابة تنويريّة، وإنّما إشباعًا لمتطلّبات الرأسماليّة وصعودها الاحتكاريّ. وبالتالي، تكوّن المجتمعات عبر شبكة من الأدوات والأجهزة الّتي تُنتِج وتنظِّم العادات والممارسات الإنتاجيّة، شرط الامتثال لأوامره وآليّات احتضانه وإقصائه عبر المؤسّسات الضابطة (السجن أو المصنع أو المصحّة... إلخ). في سياق المستوطنات. يخضع السمسار الفلسطينيّ لآليّة الضبط الاستعماريّة (المصنع)، في ما تخضع المرأة العاملة لآليّة الضبط (السمسار) الناتجة عن آليّة الضبط المستعمِرة (الاستعمار). هذا ما تعنيه التكنولوجيا السياسيّة للجسد بالمفهوم الفوكويّ.
تطبيع العنف وتحييده
من الصعب تتبّع التحرّش الجنسيّ في النساء الفلسطينيّات داخل المناطق المعتمة (المصانع)، لسببين: الأوّل، تشكيل المجتمع الفلسطينيّ صورة نمطيّة سلبيّة عن المرأة العاملة في المستوطنات، لأنّ صوتها لا يزال غير مسموع. والثاني، التزام نسبة كبيرة من العاملات اللواتي تعرّضن للتحرّش الصمت، نظرًا إلى استحالة حصولهنّ على حقوقهنّ، وخوفهنّ من نظرة المجتمع، أو خسارة عملهنّ. لكنّ الملاحظ في الآونة الأخيرة، الصعود اللافت لنقابة «معًا» العمّاليّة، وخطابها التطبيعيّ للاحتلال مقابل شيطنة الفلسطينيّ بوصفه بالمتحرِّش في العاملات أثناء وقوفهنّ على الحاجز.
يقدّم المنشور عبر حسابهم على فيسبوك خطابًا واضحًا، مفاده إعادة الشعور بالأمان للعاملات الفلسطينيّات اللواتي ’يعبرن‘ إلى عملهنّ، لأنّ الفلسطينيّ يتحرّش بهنّ نظرًا إلى عدم وجود حدود تفصل مسلك الرجال عن مسلك النساء. لذا، قرّرت المنظّمة احترامًا لهنّ فصل مسلكهنّ عن مسلك الرجال. وما قدّمته النقابة هو المشاركة في تطبيق هذه العمليّة على أرض الواقع. على الرغم من أنّها نقابة يساريّة ضدّ النيوليبراليّة، وتسعى إلى استعادة حقوق العمّال، إلّا أنّها تستخدم الخطاب المألوف المتمثّل في تلميع صورة الاحتلال على حساب الفلسطينيّ، فهي لا ترفض الحاجز، ولا ترفض الاحتلال، وإنّما تقدّم تسهيلات لأنسنتهما[2] مقابل نزع الفلسطينيّ من إنسانيّته بتحويله إلى حيوان لا يسعى إلّا وراء غريزته.
تظهر العنصريّة بوضوح في التعليقات الّتي كتبها الإسرائيليّون، ومنها: "أحسنتم، فعلتم شيئًا مهمًّا جدًّا. لكن بالنسبة إليّ، أرجو تغيير صياغة ’إهانتهنّ‘. لا يتضرّر شرف إحداهنّ عندما يعتدي عليها الرجل جنسيًّا". وآخر كتب: "دع العرب يستمتعون. في الواقع ليست خطوة جيّدة لأنّهم سيتكاثرون..."، وآخر: "الفصل بين الجنسين، التمييز، أين المنظّمات الليبراليّة؟".
أُحيلت دلالات العنف إلى رموز عنصريّة، تُستخدَم في سبيل تعزيز التمييز ضدّ الشعب الفلسطينيّ، تحت مسمّى الاحترام والحماية من التحرّش الجنسيّ. لكن، ماذا عن التحرّش الّذي تتعرّض له العاملات في المستوطنات من المستوطنين أنفسهم؟ ماذا عن العمل دون تصريح؟ وماذا عن الحاجز نفسه الّذي ينتهك كرامة الإنسان ويستبيح مكانه وزمانه؟ إنّ التلويح بشعارات حماية المرأة، وتحييد مفاهيم العنف من المستعمِر إلى المجتمع المستعمَر، يُظهِران آليّة اشتغال هذه المؤسّسات على ’لاسيقنة العنف‘ أو نزعه من سياقه؛ فالحالة الطبيعيّة هي عدم وجود احتلال ولا حاجز.
التمويه وفرض الصمت
يُستخدَم التمويه في هذا السياق للكشف عن طريقة إخفاء الدولة الاستعماريّة للعنف، بحيث يبدو منفصلًا عنها. يذهب التمويه إلى ما هو أبعد من مجرّد التمييز بين القانون والجريمة، بين المخدوع والمخادع، بين الأصل والمقلّد. التمويه لا يمزج فقط بين ما يمكن التنبّؤ به لتحليل أداء الدولة، ولكن من خلال التعتيم على أيّ تمييز واضح بين ما هو قانونيّ، سياسيّ أو إجراميّ.
على مستوى العلاقة بين العاملة الفلسطينيّة والسمسار، نلاحظ نوعًا من فرض الصمت على المرأة، وأسمّيه صمتًا أدائيًّا لأنّه يشتغل في الخفاء على البنية المجتمعيّة نفسها. مثلًا، وجود مواصفات جسديّة معيّنة للمرأة...
أمّا على مستوى العلاقة بين العاملة الفلسطينيّة والسمسار، نلاحظ نوعًا من فرض الصمت على المرأة، وأسمّيه صمتًا أدائيًّا لأنّه يشتغل في الخفاء على البنية المجتمعيّة نفسها. مثلًا، وجود مواصفات جسديّة معيّنة للمرأة، أو كونها من منطقة جغرافيّة معيّنة، وطبقة اجتماعيّة معيّنة، يمنحها شرعيّة أكثر من غيرها للعمل في المستوطنة. هذا النوع من الصمت ليس مخفيًّا تمامًا، ويسمّى أدائيًّا، لأنّه يُظهر نمطًا خفيًّا من التفاعل بنيويًّا. لا يتعلّق الأمر في إجبار المرأة على إخفاء العنف الّذي تعرّضت له، ولكنّه يطال أيضًا تعريفها للعنف في حدّ ذاته، الّذي لا يشارك فيه المستعمِر وحده. آليّة اختيار السمسار الفلسطينيّ للمرأة هي عنف خفيّ، وغالبًا ما يتمّ تجاهله عند التفكير في قضايا التحرّش الجنسيّ في المرأة الفلسطينيّة. هذا يبرهن على أنّ العلاقة بين الأمن واللاأمن، والظهور والإخفاء، هي عنصر حاسم في فرض الهيمنة؛ فالتمويه والصمت الأدائيّ غير مرئيّين، ولكنّهما يُستخدَمان هدفين للتنظيم والتحكّم.
ختامًا، بيّن لنا الصمت الأدائيّ كيف يمكن أن يكون حضور الأنساق الخفيّة سببًا في الكشف عن الآثار الاستعماريّة، وخلقها لمجتمع فلسطينيّ منضبط. صحيح أنّ حضوره كشف عن آليّة عمل سلبيّة، لكنّه في الوقت نفسه ظهر كطريقة من طرق المعرفة. وبرهن لنا على أهمّيّة تفكيك خطاب الصمت، والنظر إليه كنسق لغويّ قائم بذاته ضمن سياق تفاعليّ، سواء على المستوى السلبيّ أو الإيجابيّ. كما بيّن لنا ضرورة تجنّب عزل التحرّش بالمرأة الفلسطينيّة العاملة في المستوطنات عن سياقه، والنظر إليه بوصفه جزءًا من الحالة الاستعماريّة الكلّيّة، لأنّه كما أسلفنا أعلاه، اشتغلَت المؤسّسات اليساريّة على تشويه صورة الفلسطينيّ، وتطبيع الاستعمار تحت ذريعة حماية كرامة المرأة الفلسطينيّة المستباحة بالأساس.
إحالات
[1] N. Shalhoub-Kevorkian. Palestinian women and the politics of invisibility: Towards a feminist methodology. Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding, Shalhoub-Kevorkian, 3(1), 1-21.
[2] إيال وايزمان. وسائل الموت. في: سلطة الإقصاء الشامل: تشريح الحكم الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، (لبنان: مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2012)، ص 689-645.
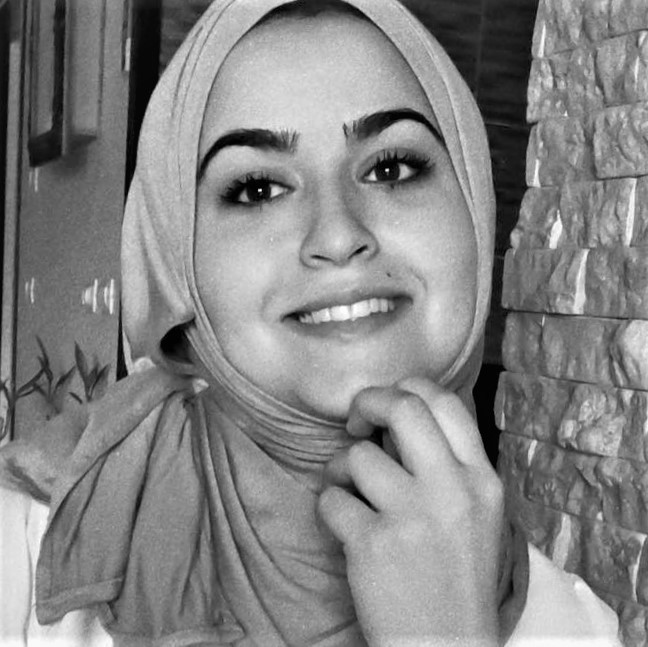
كاتبة فلسطينيّة من مواليد مدينة بيت لحم عام 1999، دَرَسَتْ «الإعلام» في «جامعة بير زيت»، وصدرت لها عدّة روايات، وتكتب في عدد من المنابر الإعلاميّة الفلسطينيّة والعربيّة.





